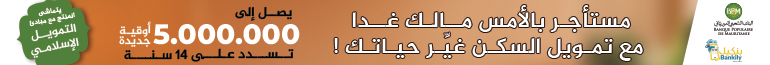في الوقت الذي تتسارع فيه التحضيرات لعقد الحوار الوطني الشامل، وتُبذل جهود وطنية من مختلف الأطراف لوضع لبنات توافق جديد، تبرز – من حين لآخر – محاولات لإقحام ملف “الهويّة” ضمن أجندة الحوار، وكأننا بصدد أمة لم تتعرف بعد على نفسها. إن هذا الطرح، بكل وضوح، ليس بريئًا ولا بريئًا في مقاصده، ولا يُعبّر عن أولويات المواطنين الحقيقية، بل يوحي وكأن الهوية الوطنية موضوع خلافي أو محل مساومة. والحال أن الهوية الموريتانية راسخة الجذور، محسومة المعالم، متجذرة في الإسلام عقيدة وسلوكًا، وفي العربية لسانًا وثقافة، ومحصنة بتاريخ طويل من التراكم الحضاري والاجتماعي.
الهويّة ليست قرارًا إداريًا ولا توصية حوارية.
الهويّة ليست بندًا تفاوضيًا، بل هي نسيج حيّ صاغته الجغرافيا والتاريخ، وثبّته الدين، وأكّدته الممارسة اليومية لمجتمع موحد في عمقه، رغم تنوعه الثقافي واللساني. الهوية الموريتانية تشترك فيها كل مكونات المجتمع دون استثناء، بمرجعية واحدة: الإسلام، وبلسان عربي جامع، يعبّر عن الدولة ومؤسساتها.
أرقام الواقع لا تجامل أحدًا.
رغم تقديرنا لكل المكونات، فإن المجموعات الزنجية لا تتجاوز في مجموعها 10% من سكان البلاد، وتتكون أساسًا من البولار، ثم السوننكي، ثم الولف. وهي مكونات عزيزة وشريكة في الوطن، لكنها لا تمثّل أغلبية، ولا يجوز أن يُبنى على أقلّيتها مشروع يناقض هوية الأغلبية. أما البيظان، فهم يمثلون أكثر من 90% من السكان، وهم حَمَلة الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وعماد التاريخ الوطني، لكنهم لم يسعوا في يوم من الأيام إلى الإقصاء أو الهيمنة، بل ظلوا دعاة وحدة وتماسك، ومشاركين في الحقوق والواجبات.
الهوية ليست نفيًا للتنوع، بل إطارًا جامعًا له.
الحديث عن “إقصاء” لا يستقيم، لأن الجميع مسلمون بنسبة مائة في المائة، وهذا يكفي لتوحيد الانتماء. الهوية لا تُبنى على الإثنيات، بل على المشترك الجامع، ونحن في موريتانيا نملك ما لا تملكه كثير من الأمم: دين واحد، لغة جامعة، ووجدان مشترك.
النماذج العالمية تتحدث لصالحنا.
من أراد أن يتعلّم، فلينظر إلى الهند، تلك القارة المتنوعة بأديانها وأعراقها، ولغاتها وقد استطاعت أن تخلق لغة موحدة وهوية هندية جامعة. انظروا إلى الصين، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، تركيا، إيران… كلها أمم متعددة الأعراق، لكنها لم تفرّط في مركز الهويّة. أما في إفريقيا، فقد كانت النتيجة مؤسفة: فقدان الهوية، والارتهان للثقافة الاستعمارية، وتفكيك المجتمعات ، حتى لم تعد الأجيال تعرف إلا لغات المستعمِر وتاريخه وثقافته.
اليوم، بدأت بعض الدول تُراجع نفسها، كما في النيجر التي تبنّت لغة “الهوسا” لغة رسمية أولى، أو مالي وبوركينا فاسو للتان بدأتا في دراسة مشروع هويه جديده بعيده عن لغة المستعمر والسنغال التي تخطو نحو استعادة لغاتها الوطنية وموروثها السيادي. لكن الثمن سيكون باهظًا، والتأخر التاريخي لا يُعوَّض بسهولة.
أما نحن، فلدينا ما نحميه، لا ما نبحث عنه.
هويتنا هي الإسلام، ولغتنا الرسمية هي العربية، وهذا لا يتعارض مع تعلم اللغات الأخرى، لكنه لا يسمح بتقويض الأصل. لا مانع من التنوّع، ولكن بشرط أن يكون تنوعًا في ظل الوحدة، لا وسيلة للتشكيك أو الابتزاز السياسي أو فرض تصورات دخيلة على واقع البلد.
ختامًا:
على طاولة الحوار الوطني، ينبغي أن تكون الهوية الوطنية مرجعية لا موضوعًا للنقاش، وأن يُفهم أن أي محاولة لإعادة تعريفها خارج هذا الإطار، لا تُهدد وحدة الدولة فحسب، بل تعبث بأسس قيامها، وتفتح الأبواب أمام نماذج الانهيار التي رأيناها في محيطنا القريب.