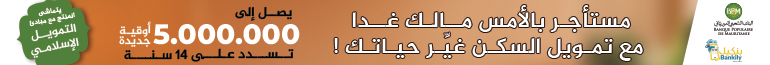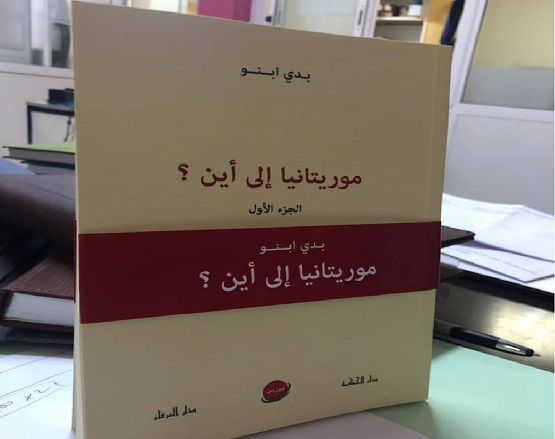
كتاب: "موريتانيا إلى أين؟" للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.
من الحركــــــــــــــات السرية إلى الحزب
مثّلَ التخوفُ من طرْح الملفات السياسية الذي حَشرَ شيئا فشيئا تشكيلات المعارضةَ في الزاوية الحقوقية أحدَ انعكاسات التجربة التي عرفتْها المعارضة الحزبية غداة الاقتراع الرئاسي لسنة 1992. إنها تجربة التفكّك المزدوج: من جهة أخذ يظهرُ بشكلٍ لافت تراجعُ حراكِ فئاتٍ كثيرة محسوبة على الُمعارضة الحزبية بعد تراجع حظوظِ سلطة الضدّ في الوصول إلى السلطة.
وهو ضعْف في النَفَس لا تفسّره الجوانبُ الشخصية ولا هشاشة القناعات الأخلاقية والسياسية الفردية إلا إذا وُضعتْ في إطارها العام، أي في إطار ضعف الانغراس الاجتماعي لهذه القناعات من جهة وضعف البنى التحتية القادرة على ضمان استقلالٍ مادي ولوجستي ولو في الحدود الدنيا عن السلطة الحاكمة.
فالسلطة تحتكر الدولة وبالتالي تحتكر الريع العام. أما الريع الخاص ففي معظم الحالات لا وجود له بما هو خاص وإنما هو ريع عام مخوصَص. إنه الامتياز الذي تَمنَحُه الدولة – السلطة.
يجدرُ بنا هنا التذكيرُ بأنّه منذ ظهور الدولة إلى الآن، فإنّ معظم - إن لم يكن كلّ - الثروات الفعلية والممكنة، كبيرة كانت أومتوسطة، هي ثروات ريعية حقّقها ذووها عبر مؤسسات الدولة، أو بواسطتها، أو بتواطؤ صريح أو ضمني مع أصحاب الحكم، أومن خلال تسهيلاتهم المباشرة وغير المباشرة.
وكانت وما تزال علاقة رجل الأعمال بالنظام هي أهمّ ما يحدد إمكانية ازدهار أعماله أو حتمية إفلاسه التام.
وغني عن القول إنّ طُرق احتكار الريع وطرق خوصَصَته، في دولة الريع المحدود، تضمن في كثير من الحالات تكسيرَ المقاومة تصاعديا واختزالَ الهوامش التي يتحركُ فيها المعارِض في المستوى الذي تراه السلطة منسجما مع إشارات الضوء الأحمر التي تعايرها وتُخضعها لموازينها الخاصة ولِما تراه منسجما مع محتوى الرسائل الضمنية أو الصريحة التي تعتقد أن عليها أن تبعث إلى الداخل والخارج.
صارتْ المقاومة السياسية مرْتبطةً إذا بالنسبة للكثيرين بالقدرة على المقاومة الاقتصادية في بلد لا يدين فيه فقط، كما رأينا، معظمُ رأس المال الخاص لرأس المال العام بل أصبح فيه "السلطان تاجرا" بالتعبير الخلدوني أي أصبح أو كاد أن يصبح فيه أصحابُ السلطة هم عينيا أصحاب رؤوس الأموال أيا يكن توظيف الأخيرة.
إلى ذلك، عرفتْ المعارضة ظاهرةً إضافية محايثة لارتباط الثروات الشخصية بالمصدر الدولتي للريع العام: فالقادرون على توفير حدٍّ أدنى من الأدوات اللوجستية التي يتطلبها النشاط السياسي هم، فضلا عن أنّ عددهم محدود، منحدرون غالبا بشكل أو آخر من داخل الأنظمة المتعاقبة على الحكم.
ويكفي لاستحضار هذا المُعطى أنْ نَتَذكّر أنّ أغلب الذين أسسوا أحزاب المعارضة أو ترأسوها في التسعينات هم من المنحدرين من الفئات التي تعاقبتْ على السلطة.
ولم يكن للمعارضة أو المعارضات الحزبية المتشكّلة داخل هوامش الخيارات المتاحة حينها بديلٌ واضح عن القبول بواجهات مُؤقتة - دائمة، يتطور القبولُ بها أو تقبّلها تبريريا مع الزمن من مستوى "الخيار المتاح" إلى مُستوى "الخيار المشروع". وشيئاً فشيئا يصبح الحزبُ رئيسَ الحزب وتصبح المنظمةُ رئيسَ المنظّمة.
فيتمّ الانتقالُ من حكم الواقع إلى حكم القيمة عبْر تطورٍ - تطويرٍ متدرّج للخطاب التبريري تنصاغُ من خلاله وفي أفقه معاييرُ مُفتَرضةٌ للقبول السياسي والاجتماعي والدولي إلخ.
إنها حالةُ الاستقطاب التدجيني المُشخصَن التي أسّسَ لها تشكّلُ الخريطة وفقَ معايير النفوذ المادي الاجتماعي اللاسياسي التي أنتَجتْها الأنظمة المتعابقة وكرّسَها النظام القائم حينها، أي النظام الذي ما زال قائماً.
تشكلتْ خريطة المعارضة السياسية في التسعينات إذًا في هامشٍ يصوغ النظامُ القائم محدداته القانونية والمادية ويرسمُ حدود ارتهانه للموروثين الرسمي و"التقليدي"، بما في ذلك ارتهانُه في حدود معينة للمرجعيات التقليدية المحدثة أو "الزومبية" وللعقلية الأبوسية ولنظرة تبخيس كلّ الحشود التي بقيتْ غير مندمجة في حلقات المستفيدين المباشرين من الريع الدولتي.
وهي المرجعيات التي زاد فاعليتها حينها تضاعفُ مسلسل إعادة مأسسة المجتمع التقليدي المحدث في الفضاء العمومي وحالة الاستقطاب العرقي الثنائي التي تفاقمتْ مع مآسي أواخر الثمانينيات.
في المستوى الثاني ظهرتْ منذ السنوات التسعينية الأولى الدرجةُ التي بلغتْها الانقسامات والصراعات الحركية التي تأخذ - هي أيضا - في كثيرٍ من الأحيان طابعَ الصراعات الماقبل سياسية، أي التي تتزاوج فيها خشبة المفردات الحديثة وكواليس المضمرات العتيقة.
لمْ يُظهر ذلك التفكّكُ هشاشةَ التحالفات المعارِضة فحسب، خصوصاً في جانبها الزبوني. بلْ أظهرَ أيضا إشكالية التحدّي الذي يطرحُه على القوى السياسية المحلّية خلْقُ مستويات جديدة من التداول السياسي تتناسب مع مرحلة مابعد العمل الحركي السري. كما تداخلَ، في ترجمته الميدانية، مع إرثْ الحركات السرية من جهة، ومن جهة ثانية معَ الخلفية الاجتماعية التي يجسّدها الاستقطابُ الزبوني "الزومبي"، ويجسّدُها تضافرياً الصراعُ المشخصَن للقيادات التي تصدّرتْ طفروياً المشهد. هذا طبعاً إلى تداخله مركزياً من جهة ثالثة مع الاختراق الرسمي المؤَجَّج والموظِّف.
وجدتْ هذه الظاهرة المتعدّدة الأبعاد أشكالا عديدة للتعبير عنها، منها تمثيلا لا حصرا الانضمامُ "الانتقامي" - في بَعض الحالات - إلى السلطة ومنها الصراعُ على المواقع داخل الأحزاب الذي مثَّلَ امتدادا شبهَ تلقائي للصراع الحركي داخل النقابات والأطر الطلابية، ومنها أيضا الصراع الحزبي بالمعنى الحصري وتفكّك وخروج عدة أحزاب من حضن حزب واحد.
ثم وصلتْ مستوى الصراع "القانوني" على مشروعية وجود هذا الحزب أو ذاك ولجوء الفرقاء أحيانا إلى المؤسسات الرسمية للخصم الحاكِم.
وهو ما سيعني عملياً "تشريعَ" استقواء طرفٍ أو آخر من الأطراف المحسوبة على المعارضة بالنظام الحاكم ضد الطرف الآخر. مما عَمِلَ بداهةً على طمْسٍ جزئي لحدود الشراكة والمنافسة والخصومة في المعارضة الحزبية.
وهو ما ساهم مع معطيات أخرى في تغييرٍ ملموس في وجهة الصراع السياسي مع السلطة وهزّ مشروعية البنى السياسية المُعارضة بالرغم من أن مشروعية الخطاب المُعارض نفسه ظلتْ مفارقيا في تصاعد.
لقد عرّتْ تلك الصراعات - خصوصا منها تلك التي تمّتْ في أجواء استحقاقات انتخابية - حجمَ العقبات التي يطرحها الانتقال من مرجعية الوزن السياسي الحركي إلى مرجعية الوزن السياسي الانتخابي لاسيما مع الاستثمار المتصاعد للشروط الموروثة عن مناخ أحداث 1989 سياقاً وتداعياتٍ، وبشكلٍ أعمّ مع استمرار آلية إعادة مأْسسة المجتمع التقليدي المحدَث في الفضاء العمومي المخوصَص.