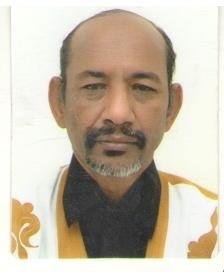 أورد المفكر المغربي والمشتغل بالدراسات المستقبلية: المهدي المنجرة، مقولة لأحد المستشرقين، يؤكد فيها أنك إذا أردت أن تهدم حضارة أمة، فما عليك سوى التركيز على ثلاثة أمور، هي: هدم التعليم وإسقاط الرموز المرجعية وهدم الأسرة.
أورد المفكر المغربي والمشتغل بالدراسات المستقبلية: المهدي المنجرة، مقولة لأحد المستشرقين، يؤكد فيها أنك إذا أردت أن تهدم حضارة أمة، فما عليك سوى التركيز على ثلاثة أمور، هي: هدم التعليم وإسقاط الرموز المرجعية وهدم الأسرة.
فلكي تهدم التعليم، عليك أن لا تترك للمعلم أية أهمية داخل المجتمع، وقلل من مكانته، حتى يحتقره طلابه.
ولكي تسقط المرجعيات ومن هم قدوة: فما عليك إلا أن تطعن في العلماء وأن تشكك فيهم.. قلل من شأنهم، حتى لا يسمع لهم ولا يقتدي بهم.
وإذا أردت هدم الأسرة، فعليك بتغييب دور الأم.. اجعلها تخجل من وصفها ب "ربة بيت".
فإذا اختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة والمرجعية واختفت الأم الواعية، فمن يربي النشء على القيم؟
ثلاثية، قد تتفاوت في شدة حضورها وترسخها نسبيا عندنا.. لكن لا خلاف على وجودها بقوة وتغلغلها داخل نسيجنا، المهلهل والمشكوك في قدرة بنيته الهشة أصلا على مقاومة العواصف والتحديات.
إنها مجرد جزء من الحكاية.. فلو تتبعنا معاول الهدم المسلطة على الدولة الموريتانية، لضاق المقام عن ذكرها، لذا فإنني في هذه المعالجة، سأركز على الخيط الناظم لها والأداة المستخدمة لتمريرها، والمتمثلة في آلية تشويه الرؤية وتزييف الواقع، حتى لا يكتشف المواطن، كم هو مخدوع في كل شيء، وحتى لا يعي حجم المنزلقات الخطيرة، والحفر الغائرة، التي يراد لوطننا- بوعي أو بغباء أو بجشع- أن يسقط فيها.
جانب من تمويه الواقع هذا وتزييفه، تكفلت به وسائل الإعلام العمومية و"شبه العمومية".
وآخر انطلى، بفعل انتشار الجهل وغياب الوعي بالحقوق والواجبات.
والبقية تكفلت بها نخبة، باعت نفسها لمن يدفع أكثر، أو يمنيها بالعطاء على الأقل- ولو بإيماءة - قد تكون دالة أيضا على النقيض.
فغالبية ممتهني "السياسة" عندنا- وليس كلهم- هم ناس يعيشون على الوهم بأنصع صوره: مناضلون بدون نضال وساسة لا يفقهون معنى السياسة، يمقتون ما تستبطنه الكتب، يتلقفون الشائعات و"يرسمون سياساتهم" على أساس الأماني والأحلام.
"ساسة" يبيعون الوهم للناس ويصدقون ما توهموا.. غالبيتهم "اعتادوا على تقبيل حذاء الحاكم، لدرجة أنهم لا يرفعون رؤوسهم، عند تغيير الحذاء، ليرو من الحاكم".
ساسة، همهم الوحيد، هو: تزييف الواقع، وتسديد السهام باتجاه نحور الشركاء في الوطن، لا لشيء، إلا لأنهم مختلفون عنهم قبليا - جهويا – عرقيا- أو شرائحيا.. خيار كفيل بتخريب البنيان، وانحراف بوصلة الحقيقة، يخدم الأنظمة التي ترعاه وترى فيه فرصتها الذهبية، لتنجوا بجلدها، دون أن تنكشف لعبتها قبل أن ترحل.
أما الشعب، فهو "منوم" في ظلمته الطويلة، لاعتماده على نخبة مدجنة ووسائل إعلام، صممت لكي تبني عالما من الأوهام.
"تزدهر" البلاد، عند ما تصبح في حالة إفلاس سياسي واقتصادي واجتماعي، وتتحول "سنة التعليم" إلى موسم لتحويل المدارس إلى "متاجر".
وينموا الاقتصاد، عند ما تتضاعف المديونية الخارجية وتتفاقم الداخلية، وتخوى الخزائن ، ويعصر المواطن - على طريقة البرتقال - ويلقى به في صراع يومي من أجل البقاء.. عندها تقدم هذه "الإنجازات" بوصفها دليلا على نجاعة الاهتمام بالفقراء ومؤشرا دالا على انتهاج سياسة تنهي الفساد والمفسدين.
- الصحة: قفزت (في الهواء)، من خلال إنشاء سيل من مراكز الإستطباب الوطني وتوفير الأجهزة المتطورة واحتكار توريد الأدوية الأساسية.. ورغم ذلك تزداد طوابير الفارين منها، باتجاه تونس والسنغال والمغرب وفرنسا، وتتكدس في نفس الوقت الأدوية المزورة في الصيدليات، لتتضاعف الخسارة المادية والصحية.
وبفضل "الحملات الصحية كذلك و"الحرب" المعلنة على الحشرات الضارة: استوطنت في العاصمة، "حمى الضنك" وأخواتها وتحولت العاصمة إلى مملكة للباعوض.
- التعليم: تعددت وزاراته وصار لكل جزيء مجهري منه قطاع يخصه، ورغم ذلك ، فقد أصبح وضع "الكراي" المادي والمعنوي ماثلا على محياه البائس وثيابه الرثة.. وبفضل "السياسات الرشيدة" أصبح رجل التعليم في ذيل السلم الاجتماعي.
غالبية مؤطري هذا القطاع اليوم، هم ناس أخذوا عشوائيا من الشارع واعتمد في "جرناليتهم" على معيار الكم على حساب الكيف، فأصبحت المدارس العمومية، شبه مهجورة، أما بدائلها الخصوصية، فهي أشبه بمحلات لبيع الرصيد منها بمؤسسات تربوية، تعنى ببناء الأجيال وتؤسس للنهضة.. لذا وصل نزيف ما قبل الباكلوريا إلى أكثر من 86% وما خفي كان أعظم.
- الأمن: سخر من أجله الحرس والدرك والشرطة وأمن الطرق.. والنتيجة: أن لا أحد آمن في بيته ولا هو مطمئن في الشارع أو داخل الأسواق.
- الضرائب: متروكة لشهية أصحاب "حظوة" جبايتها الخصوصيين، والذين تحولوا، بفعل "فاعل" إلى أوصياء على مداخيل خزينة الدولة.
- عاصمة البلاد تغرق، بفعل انعدام مجاري عصرية.. تزداد فيها وتيرة الأحياء المهجورة والمباني المتآكلة، بفعل سياسة وضع العربة أمام الحصان.
واقع جعل المعارض "المنبوذ" والمؤيد "المحقور" في حالة من عدم فهم واقع، كله ظلمة في ظلمة.. وغالبا ما يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ما الذي يجري؟ ولا أحد لديه جواب.
فكل من حاول منهم أن يسترق السمع، لم يجد، سوى جدران خرسانية، ليس لها من صدى، إلا ما تبثه وسائل الإعلام العمومية، و "شبه العمومية".
- جمالياتنا المعمارية، تحدد بمشرط انتقائي، يتصيد أفضل المواقع "الحانوتية".. ولا يهم هل هي مؤسسات تعليمية أم مرافق أمنية أو مركبات رياضية؟
تاريخنا السياسي، بني على الأوهام، بحيث تنكرنا لمن حمل السلاح ضد المستعمر ومجدنا من حمله دفاعا عنه (في قلب العاصمة علم الدولة يرفرف فوق بناية لقدماء المحاربين..أما المجاهدون فلا وجود لهم في عرف "ساسة ما بعد الإستقلال").
لقد تحول حلم الدولة، الذي رعاه الفرنسيون وبشروا به في ألاك(1958 كان ضمن الحضور: اجمان من الصحراء ووجهاء امتداداتهم القبلية أزوادية) وحموه ببنادقهم، ليتحول حلم الدولة إلى "منة" فرنسية و"هبة منجمية" (أسست الدولة لتوقع مع "ميفرما" على استخراج الحديد)، يستحق عليها المستعمر الشكر والثناء- رغم استعباده للناس ونهبه للثروات وتمييعه للهوية ومحاربته للثقافة الإسلامية وتنكيله بصفوة كانت تريد لهذا البلد وأهله الخير، كل الخير.
هذه هي موريتانيا،
التي هلل لها كثيرون، بحجة أنها "أرض الرجال"، ونموذج للحرية والإنعتاق.
ورفضها أيضا البعض، بحجة أنها جنين مشوه، يجب إجهاضه والتخلص منه قبل فوات الأوان.
فرغم أن الجميع ابتلع "الطعم" طوعا أوكرها، إلا أن هذا المصير المموه والواقع المعتم، يفرض علينا الوقوف أمام معضلات وجودية، لا يملك أي أحد من "النخبة" لها أي حل مقبول.. وليست لديه أي مقاربة تهدف إلى ملامسة أوجاع الساكنة، تتضمن حلولا، تخدم الجميع دون تمييز، بعيدا عن "المحاصصة" القبلية أو الإثنية أو الشرائحية، التي ثبت بالدليل أن ضررها أصبح أكبر من نفعها.
فما الحل إذن؟
هل نبقى في "عالمنا الافتراضي" هذا والخالي من الإبداع ومن النظرة الموضوعية لواقع الناس وتحديات الحاضر وفجائيات المستقبل؟ أم أنه ليس مقبولا لنا أصلا أن نفكر أو نقرر ما نريد؟ أليست المعضلات، هي اليوم من الإلحاح بحيث يتحتم على الجميع البحث عن حل يوقف إكراهات الحاضر وتهديدات المستقبل؟
أين عقلاء البلد؟ من الخاسر ومن الرابح من هذا الوضع المأزوم، والذي بني على الأوهام ويسير بالأوهام، ولن نجني منه، سوى "إنجازات" هي في الجوهر، مجرد أوهام؟
هل لدينا معضلات ملحة، تحتاج لمثل هذا الاهتمام الزائد؟.. وبالتالي، فكل ما يحدث هو نتيجة منطقية، تمليها مقدرات البلاد وواقعها الاجتماعي والثقافي؟ فالمواطنون- وفقا لهذا المنطق- أمام معطى، ليس لهم فيه إلا أن ينصاعوا ويستكينوا، لأننا شعب مصطنع وغير مؤهل جينيا للطموح، وبالتالي ف"مثل ما نكونوا يول علينا".. فالسكوت والخنوع، هما قدرنا.. حتى ولو كان الثمن: كرامة الإنسان وغياب أبسط حق من حقوق المواطنة الكريمة؟
ألم يضمر المشروع الوطني بعد 55 سنة من ظهور الدولة الموريتانية؟ ومن المسؤول عن ذهاب جذوة الوطنية وغياب الحس الوطني والمرجعية الوطنية؟
هل نحن أمام "وطنية" تحدد جرعاتها بحجم ما تدره الدولة على الشخص من نفوذ ومزايا اقتصادية ومعنوية؟ وهل هذا هو ما بشر به "الآباء المؤسسون"؟
كم نحتاج من الوقت، لنصلح ما أفسده حكام يبيتون ليلتهم ملهمين، لم تنجب البلاد مثلهم، ويصبحون- بفعل البلاغ رقم1- ضمن خانة المجرمين المنبوذين؟ هل لا زال في مقدور البلاد أن تتحمل واقعا كهذا؟
وهل استمرأ الجميع الدونية وأصبحوا يائسين، ينتظرون ما يخبئه المستقبل لهم بكل استسلام وخنوع؟
قد يريحنا اليوم تقليد النعامة وقد نلجأ إلى حيل نفسية، تدفع بنا إلى أحلام اليقظة، لتبعدنا عن واقعنا الصادم.. بحجة أنه ليس متاحا لنا جميعا، سوى أن نستكين لخطاب التمويه والتخدير هذا، حبا ل"السلامة" ورغبة في أن لا نخسر إذا كنا لن "نربح"، دون التفات إلى حقيقة أن العواصف عند ما تهب لا تفرق بين فرد وآخر، وأن المنافع والأضرار هما أيضا شاملتين.
، فلا بد من مواجهة واقعنا المأزوم بحكمة وروية واندفاع.. خيار يمثل أضعف الإيمان، وهو المفضي إلى أقل الخسائر بالنسبة لمن لديه صبية قدره أن يعيش وإياهم على هذه الرمال المتحركة.
فعند ما تصبح المعايير مقلوبة والحقيقة مغيبة ونتبين أن ما نسميه اليوم بدولة، ليس في الواقع، سوى خصخصة للمرفق العام لصالح من يتولى تسييره، ودولة عميقة، نشاهد اليوم ضررها البالغ على بلدان الربيع.."دولة" تحكمها سادية اتجاه بني وطنها وترى في الداعين إلى الإصلاح، مجرد "حشرات" يجب رشها بالطلقات القاتلة، وإبادتها بالكامل، دون رحمة أو شفقة.
خياران أفرزهما واقع البلد وقدمت تجارب الشعوب حولهما أعمق الدروس:
- فإما الاستكانة والتفرج على هذه المسرحية الهزلية والواقع السيزيفي وتقبل معايشة واقع مموه وموهوم والتغاضي عن الدولة العميقة وتركها تعشعش وتفرخ.. وعندها ستتضاعف الأثمان، التي سيدفعها الوطن، كلما طال الوقت وبفعلها، سنغيب- كشعب- عن الفعل ونصبح منفعلين، ننتظر الفتات غير المؤكد وسنخسر حتما آدميتنا وكرامتنا الإنسانية.
- وإما أن نمزج بين الحكمة في تقدير المعطيات، والشدة في مواجهة ما يبيت ويحاك ضد وطن لا نتوفر جميعا على بدائل عنه.. فالأوطان لا تعوض ولا تبنى في الغرف الظلامية والمظلمة وإنما بسواعد الخبراء وعقول الساسة وتخطيط الساهرين وتقديم الواقع كما هو.
أما الأوهام والمعطيات المموهة والأرقام المغلوطة والخطابات الممجوجة، فهي بضاعة بارت وانتهت صلاحيتها، ويجب أن يعرف سدنتها أن دوام الحال من المحال وأننا أمام لحظة جديدة، ستصبح خلالها حقبتهم الحالية وشبيهاتها السابقة، مجرد جزء من عالم النكتة ومجالا للتندر والاستهزاء.
ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء "منا".



.jpg)







