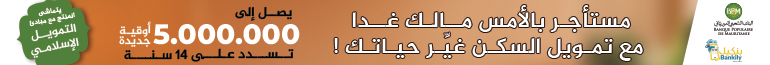في ستينات القرن الماضي والدولة حينها في طور التخلق، خرج أحد رجالات الدولة آن ذاك على التلاميذ المضربين وخاطبهم قائلا: " لقد أزعجتم الدولة وهززتم مصداقيتها، نحن لا يهمنا تعليمكم بقدر ما يهمنا أن تكون لنا مؤسسات دولة، فإذا لم ترعووا وتعودوا للنظام فإننا سنملأ مؤسساتنا بتلاميذ
في ستينات القرن الماضي والدولة حينها في طور التخلق، خرج أحد رجالات الدولة آن ذاك على التلاميذ المضربين وخاطبهم قائلا: " لقد أزعجتم الدولة وهززتم مصداقيتها، نحن لا يهمنا تعليمكم بقدر ما يهمنا أن تكون لنا مؤسسات دولة، فإذا لم ترعووا وتعودوا للنظام فإننا سنملأ مؤسساتنا بتلاميذ
من الدول المجاورة ونستغني عنكم وعن مشاكلكم التي لا تنتهي "؛!!! وبعيدا عن صاحبنا، وبغض النظر عن نواياه، هناك في عالم المشاريع، صاح الفيلسوف الألماني "فيشته" بعيد اجتياح القوات الفرنسية لبلاده قائلا : " لقد خسرنا كل شيء، لكن بقيت لنا التربية "، إيمانا منه بقدرتها على تعويض كل الخسائر، والنهوض بالأمم من الصفر،؛ وصاح اليابانيون نفس الصيحة بعد الحرب العالمية، وكذلك صاحت كل الأمم التي لها مشاريع، وبالتربية وصلت إلى المجد والسؤدد والرقي!!!
إن التربية تصنع المعجزات، ولكن لا تصنعها إلا لأمة صاحبة مشروع طموح، وتعرف قيمة التربية وكيف يمكنها الإقلاع بها بأمان إلى بر الأمان، إنه التخطيط ورسم الغايات، وليس مجرد المحاذاة! خصوصا وأننا في زمن تعقدت فيه جميع مناحي الحياة وتغيرت فيه نواميس الكون، حتى لم يعد الطفل طفلا بالمعنى الفيزيولوجي، بل أصبحت الطفولة تتحدد اجتماعيا حسب رقي المجتمع وتخلفه، وحسب إعداده لنشئه لمتطلبات الحياة، فالحياة المعاصرة تتطلب الكثير من الإعداد وبالتالي إطالة فترة الطفولة،؛ والحياة المعاصرة لم يعد التعليم فيها عالة على الاقتصاد كما كان في عهد الاقتصاد الريعي البسيط، الذي تكفيه سواعد الرجال وهوامع الأمطار، بل أصبح فيها الاقتصاد عالة على التعليم، فلقد أحدثت تطبيقات العلم والتكنولوجيا تطورات هائلة في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، وفرض هذا التطور ضرورة إعداد الفرد في العصر العلمي التكنولوجي إعدادا يختلف إلى حد كبير عن إعداده السابق، وحيث أن النمو الاقتصادي هو مطمح كل الشعوب والدول في العصر الحديث وصمام أمانها أمام كل الانزلاقات الناجمة عن الفقر وعدم المساواة فقد ازدادت أهمية التربية كأداة لتحقيق هذا النمو،؛ وليست التربية أداة لتحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل هي كذلك أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وذلك بما تضمنه من تعايش وما تقوم به من صهر للأجيال وبما تعمل عليه من نقل لعموميات ثقافة المجتمع وتشكيل وتقليص خصوصيات هذه الثقافة، فالعامل الثقافي من أهم وآكد عوامل الوحدة والانصهار.
إننا اليوم وعندما نلقي نظرة على تعليمنا لمعرفة في أي الكفات هو، أفي كفة المشروع أم في كفة المحاذاة سنجد الجواب الشافي عندما نحلل أوضاعنا المعاشة، سواء الوضع الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الأخلاقي والقيَّمي وحتى الوضع السياسي، إن ما يعيشه المجتمع اليوم من اصطفافات عرقية وطائفية وفئوية وما يصاحبها من دعوات لثقافة داخل الثقافة وكيان داخل الكيان ومجتمع داخل المجتمع ودولة حتى داخل الدولة وما نتج عن ذلك من تجفيف للعواطف وتجييش للمواقف وزرع للكراهية بين أعضاء الجسد الواحد، كل ذلك يعود إلى خلل في التربية التي من وظائفها صهر المجتمع وتوحيد عموميات ثقافته وتطويرها وتقليص الخصوصيات وتأطيرها، وتوزيع العدالة واحترام آدمية الإنسان.
أن اقتصدنا مازال ريعيا بسيطا في مجمله يعتمد على ما تجود به السماء من ماء، وما تجود به الأرض من خام، وما يجود به البحر من سمك، لا دخل لتطبيقات العلم والتكنولوجيا فيه، الشيء الذي انعكس علينا رغم قلة العدد وتعدد الموارد، فهل أنتج تعليمنا كفاءات قادرة على صبغ هذه الموارد بالصبغة العلمية مما يجعلها وسائل رفاه وسعادة للوطن والمواطن، أم أنه لم ينتجها في الأصل، وبالتالي بقيت عالة على أدمغة الغير الذي يستغلها ولا يعطينا منها إلا القشور؟ أم أن تعليمنا لم يُخلق أصلا لإعداد مثل هذه الكفاءات، إنما يُعِدُّ الإنسان مثل ما يُعِدُّ البحر الأمواج التي سرعان ما تتحطم وتنكسر وتتلاشى في نهاية رحلة لا هدف لها؟ قد يقول قائل إن الإرادة السياسية هي ما تنقص! لكن من الذي يخلق الإرادة السياسية؟ أليس التعليم الجيد ذو الأهداف والمشاريع هو ما يخلق تلك الإرادة ويمدها بالضمير المهني والوطنية؟.
أما على المستوى الأخلاقي والقيَّمي فإن ما يعاني منه المجتمع من اغتراب فكري وانحلال أخلاقي وفراغ روحي وتيه بصفة عامة، إنما هو ناتج عن غياب الأسس الفلسفية والاجتماعية في بناء المناهج التربوية، فلكل أمة فلسفتها الاجتماعية والعقائدية والقيمية التي تسعى من خلال التربية إلى ترسيخها والمحافظة على تميزها بها، غير أن مشكلتنا هي مسيرة اللصق والنسخ التي عرفها نظامنا التربوي، والتي جعلته كشكولا من مختلف المشارب والجنسيات والفلسفات وكانت نتيجة تطبيقه على أرض غير أرضه وواقع غير واقعه هي ما أنتجت لنا جيلا تائها مغتربا يبحث عن ذاته في هذا الشتات غير المتجانس، ولا غرابة إذا ضل السبيل في تلك المتاهات!!!
إننا ومنذ أن عرفت عقولنا التفكير منشغلون ومنهمكون في الشأن السياسي، تحليلا وتنظيرا وصراعا، لا صوت يعلو صوتَ السياسة وصراعاتها، وكأن كل معاناتنا في هذا المجال، لا تجد من يلتفت إلى المجالات الأخرى إلا بشكل نادر وخجول،! وليس ذلك إلا بسبب غياب التخصص والإيمان بما هو متاح منه، فالتربية السليمة تنتج متخصصين في مختلف المجالات منشغلين بمجال تخصصهم بالدراسة والتحليل والتنظير والتخطيط للرفع من شأنه، و هكذا تتطور وتتقدم وتنمو كل المجالات بالتوازي والتزامن.
إن كل ما نعاني منه اليوم من فقر، ومرض، وجهل، وتفاوت، وتفكك، وتطرف، واغتراب، وتيه، وإلحاد، إنما هو بسبب غياب المشروع المجتمعي الحضاري في التربية التي تنحصر عندنا مع الأسف في مجرد مباني ولوازم مدرسية وطواقم إدارية وتربوية تعاني هي الأخرى من ضعف التكوين والإمكانات.
شفى الله تعليمنا