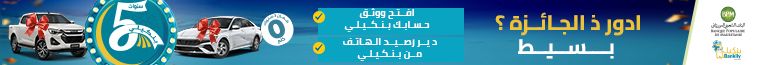كان أول قرار أتخذه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عزل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عن قيادة جيوش المسلمين وتعين أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح خلفا له ، وكان جواب خالد الذي قاد أول معركة ضد الروم وعبر بجيوش المسلمين إلى العراق فالشام بعد أن أخمد ثورة المرتدين "السمع والطاعة لأمير المؤمنين" رغم أن في نفسه شيء من أسباب عزله فلم يكن بلاءه ناقصا ولم يقصر يوما
كان أول قرار أتخذه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عزل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عن قيادة جيوش المسلمين وتعين أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح خلفا له ، وكان جواب خالد الذي قاد أول معركة ضد الروم وعبر بجيوش المسلمين إلى العراق فالشام بعد أن أخمد ثورة المرتدين "السمع والطاعة لأمير المؤمنين" رغم أن في نفسه شيء من أسباب عزله فلم يكن بلاءه ناقصا ولم يقصر يوما
وما هُزم في معركة ، وواصل في المرتبة أو الوظيفة التي حددت دوره داخل الجند كما أمر بذلك وليّ الأمر الجديد ، ورغم كل الشكوك التي أحاطت بقرار عمر رضيّ الله عنه فإنه ظلّ مصمما عليه إلا أن اعتزل خالد ، و أدرك قبل موته بأن قرار عمر صائب وأنه لم يكن مستهدفا لشخصه هو دون غيره وإنما كانت قاعدة عامة عنده طبقها على الجميع.
عمر خاف أن يفتن الناس بخالد ولم يحسده وإنما أراد أن يُثبت لعوام الناس أن النصر نصرٌ من عند الله وليس من قوة خالد ولا شجاعته وفعلا كان ذلك ، فلقد كاد الناس يفتنون من كثرة حديثهم في تلك الفترة عن فتوح خالد وبلائه في المعارك ، وعمر كذلك طبق قاعدة عامة على جميع القادة والحكام دون استثناء فمن كان فيه خير فقد جُرب ومن كان سيئا فيكفي الناس سوؤه .
حدثني أحد شباب التيار الإسلامي في موريتانيا عن زعيمهم السابق حديثا عجبتُ كثيرا منه فهو عنده ليس كالبشر لا يخطئ ولا يكذب ولا يحسد ولا يوجد ما هو أوسع منه ثقافة واطلاعا بل هو بكل المقاييس "مفكر" وطبعا من أعجبُ بشخص له الحق في شكره لكن أن يكون منتسبي مؤسسة ذات توجه إيديولوجي كلهم لديهم نفس الفكرة فهذا أمر جد صعب ، خصوصا إذا ما نظرنا نظرة موضوعية وبحثنا في المعاجم اللغوية والنظرية عن المفكر لغة واصطلاحا وعن دوره المستحق والفعلي داخل المجتمع وعن مكانته العلمية الحقيقية التي لا مراء فيها ، وحاولنا إسقاط تلك الأوصاف على الموصوف الذي هو بين أيدينا دون تجريح ولا تنقيص!!
تذكرتُ حينها أهم النقاط التي ركز عليها الكاتب والمثقف الكويتي عبد الله النفيسي في كتابه عن نقد جماعة الإخوان المسلمين ، حينما اعتبر أنهم جماعة حزبية أكثر وأن لديهم أزمة تضخيم القيادة وهي ما اعتبرها أكبر معضلة تواجه مشروعهم الفكري الإسلامي .
طبعا هناك عوامل مختلفة يُنتج من خلالها المجتمع وجهاءه ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ، وتبقي في كل تلك الحالات الاجتهادات الفردية حاضرة والخيارات الفردية كذلك ، فمن تميز في موقف كان ذكره واجب بما صنع ، ولقد ميز ماكس فيبر باعتباره أهم من تناول الموضوع بين أنماط مختلفة من السلط ، تظهر من خلال كل واحدة منها الخصائص الفردية وحضورها والعوامل الجينالوجية الوراثية كذلك وحضورها ،واعتبر أن السلطة الكارزمية يقودها شخص ملهم ، في حين أن السلطة العقلانية هي التي تحكم بالقانون ، ثم السلطة التقليدية التي تحكم بالأعراق والقوانين المتوارثة واعتبر أن الأخيرة مرت بثلاث أنماط في تاريخها ،ومن المؤكد أن ماكس فيبر توصل إلى هذه النماذج والأنماط السلطوية من خلاله دراساته التاريخية عن أشكال السلط ومقارنتها بالواقع الأوروبي في ذلك الوقت الذي يتجه نحو بلورة نموذج سلطوي عقلاني تأخذ فيه الخصائص القانونية والإدارية حقها ويكون القانون هو الحاكم والأشخاص مجرد وسائط فقط .
وربما كان النموذج الذي نتحدث عنه مختلف أو هو أقرب إلى الشكل الكارزمي الذي اعتبر أن صاحبه يملك خصائص وسمات خارقة تجعله يتقدم لا محالة في جماعته وأهله مع استبعاد السبب الذي فسر من خلاله فيبر الاعتقاد بالخصائص الشخصية إسقاطا على فاعلينا الذي نتحدث عنهم أو نصفهم في هذه الأسطر .
لقد غاب عن فيبر وهو يقدم نظرية استخلصها من دراسة تاريخية يبدو أنها معمقة وطويلة الجانب الإعلامي الذي يضخم الشخص ويقدمه في شكل مخالف لشكله وبطريقة تخدم المحيطين به أكثر منه هو شخصيا ، وهو ما نشهده الآن في أي منظمة حزبية أو أي قوى حية لها غايات سياسية معينة .
وطبعا الدراسات التي أوصلت فيبر إلى تقديم هذه الأنماط السلطوية الخاصة نوعا ما بتاريخ المجتمعات الغريبة ، نفسها التي أوصلت ابن خلدون إلى استنتاجات مهمة في نفس السياق انطلاقا من دراسة معمقة وفردية عن تاريخ المجتمعات العربية الإسلامية السياسي وهو في عصر شهدت فيه المجتمعات العربية أنواعا مختلفة من الاقتتال والحروب البينية واعتبر أن العرب لا يمكن توحيدها إلى من خلال رسالة ربانية وفيها تتجسد معالم السلطة الكارزمية عند "فيبر" أو دعوة دينية ، ذلك نتيجة لطبيعة الأعراب وميولهم إلى الخلاف والاختلاف أكثر من ميولهم إلى الاتفاق والتفاهم .
ومن خلال هذا وذلك فإنه وإن صح توفر بعض مما بيّن بن خلدون فإن الغايات التي ترسم أهداف ذلك المشروع تجعله مقززا أكثر لدور الإسلام الريادي وحاصرا له في نماذج التفكير الحزبي الموغل في الدوغمائية دون أن نقرّ تواجد أي نوع من النماذج الكارزمية المميزة من خلال تاريخ الممارسة في مؤسسة حاولت أن تتميّز عن غيرها بطابع بيروقراطي خاص مع محاولة ربط االمنتسبين بسمات القادة ومحاولة تضليل الرأي العام بتصويب الاهتمام نحوهم والتحدث بأوصاف مخطئة في حقهم هو أكبر خطئ تاريخي .
من حق أي مؤسسة أو بناء التنظيمي أن يحترم قياداته لكن ليس من حقهم أن يوهمهم بإطلاق أوصاف قد تتعدى التموقع الحزبي أو الآيدلوجي ، فحاجة المجتمع إلى مفكر أعظم من حاجته إلى قائد حزبي ، نظرا لعظم الهوة المتواجدة بين المجتمع وتنظيماته التي أفرضت عليه في كثير منها محاذاة أو استنساخا لتجارب أخرى مخالفة