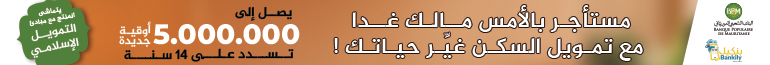من سنن التاريخ أن الدولة حين تُحسن البناء تستغني عن الشعارات، وتستغني عن الأعداء. أما حين تعجز، فلا تجد أمامها إلا وهم العدو لتُخيف به الشعب، وصدى الشعارات لتُسكت به صوت الجوع والفاقة.
الهدم، في يد السلطة العاجزة، ليس خيارًا فقط بل ضرورة وجودية؛ وليس تكتيكا عابرا بل استيراتيجية مستمرة لأنها لا تملك أدوات التشييد، فتصوغ أدوات التفكيك. فالهدم أيسر من البناء؛ فهو أسرع، وأقل كلفة، ويُنتج ضوضاء تغطي على صمت المنجز الغائب.
ففي عالم السياسة، الأنظمة الرشيدة القوية لا تحتاج إلى اختراع أعداء لا خارجيين ولا داخليين. يكفيها أن تُنجز، فيرى الناس بأم أعينهم معاني الرفاه، والعدالة، والكرامة. أما حين تعجز عن ذلك، فإنها تميل إلى الخيار الأرخص: صناعة الخوف، وتأجيج الفُرقة، وتحويل فشلها إلى مؤامرة دائمة.
فالهدم، في يد الحاكم العاجز، ليس فوضى، بل سياسة.
سياسة تُدار بأدوات متعددة: إعلام يُشيطن ويُلمّع، أجهزة تُرهب وتُغري، ومعارضة شكلية تُربك وتُضلل، ومجتمع تُزرع فيه بذور الشكّ والريبة والانقسام.
ولأن البناء يتطلب رؤيةً ومؤسسات، والهدم لا يحتاج سوى إلى فتنة وخطابات تؤججها وشائعات تغذيها، تُفضّل هذه السلطات الهدم، وتُراكم الخراب وكأنه منجز.
وليس هذا بدعًا من القول، ولا خرافة معاصرة، بل قاعدة تاريخية وسُنّة تتكرر عبر التاريخ.
ففي أواخر العهد الأموي، حين ترهلت الدولة، وفقدت مشروعها الرسالي، بدأ الخلفاء يُلهون الأمة بحروب داخلية على الولاء، يفرقون بين عدنان وقحطان، وبين مضر وربيعة، وبين قيس وإلياس، ويستثمرون في العداء القبلي، حتى كانت نهاية الدولة على يد خصومها من داخلها.
وفي أواخر عهد العباسيين، حين تفككت الأطراف، وتنازع الوزراء وقادة الجند، لجأ السلاطين والخلفاء إلى تأليب طائفة على أخرى، وزرع الفتن داخل البلاط وخارجه، ظنًا منهم أن السلطة تُحمى بالخصومات، لا بالعدل.
وسقطت بغداد، لا لأن المغول أقوى، بل لأن الدولة كانت مشلولة من الداخل، مأكولة بالهدم الذاتي.
وفي الأندلس، قبيل سقوطها، شهدت ممالك الطوائف فصولًا مشابهة من المهزلة السياسية: أمراء يتآمرون على بعضهم، يستنجدون بالأعداء الخارجيين لإضعاف بعضهم، يُشعلون النعرات العرقية والجهوية بين العرب والبربر والمولدين والقوط، لا فرق عندهم بين الدور والركام ولا بين الخشانات والرماد ما دام العرش قائمًا فوقها.
أما في التاريخ الحديث، فإن الأمثلة أكثر قُربًا.
في عهد الشاه بإيران، حين اختنق النظام بفساده، وابتعد عن شعبه، زرع جواسيسه في صفوف المعارضة لتفتيتها، وشجع ذوي النزاعات القومية على الظهور والصدارة في الساحة لإسكات أصوات الساسة الوطنيين، ففقد الجميع الثقة في الجميع، ومع ذلك سقط الشاه في لحظة لم يكن يتوقعها.
وفي رواندا، قبل المجازر، غذّت السلطة التفرقة بين "الهوتو" و"التوتسي". وروّج الإعلام لخطاب الكراهية حتى صار الجار يذبح جاره، لا لأن بينهما مشكلة، بل لأنه ينتمي إلى "القبيلة الأخرى".
وفي بلدان عربية معاصرة، نراها تُعيد تدوير هذه الوصفة القديمة بشكل لا يقل قتامة.
من العراق ما بعد صدام، إلى ليبيا ما بعد القذافي، إلى سوريا واليمن، وحتى دول أخرى لم تسقط رسميًا لكنها انهارت مؤسساتيًا، تتكرّر القاعدة ذاتها: السلطة التي لا تملك مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، تزرع الخصومات، وتُجيّش الولاءات، وتُعيد تدوير الخراب باسم الاستقرار
حين تعجز الدولة عن تحسين معيشة المواطن، تُطور قدراتها في قمعِه، وقمعُه يكون ببعضه، وحين تفشل في تنمية موارده، تُنمي أدوات تنغيص حياته، وحين لا تجد ما تُقدّمه له، تُقنعه أن بقاءها وحده هو "المنجز الأعظم" وأن مصيره مرتبط بمصيرها، فإن سقطت سقط.
والأدهى أن بعض هذه الأنظمة تُشجع من يعارضها شكليًا، وتُلمّع وجوهًا تزعم النضال، لكنها في جوهرها ليست إلا صدى لخطابها، تُنفّذ سياسة تفتيت المجتمع، وتخدير الوعي، وزرع الخصومة في كل شارع وبيت.
وتحت هذه الأنظمة، تُفرَّغ المعارضة من معناها، ويُختلق عدوٌ داخلي في كل زاوية، ويعاقَب الوطنيون إن رفعوا صوتهم ويُكافأ العميل إن أتقن دور المعارض المصنوع.
فليس الهدف الإصلاح، بل إتقان لعبة التشويش
إن أخطر ما تفعله هذه الأنظمة ليس أنها تهدم، بل أنها تُقنع الشعب أن الوضع القائم هو أحلى الأمرّين فتوغل في الهدم وتشجع الانقسام وتقنعه أن بقاءها هو الحصانة من الفوضى والانهيار.
لكن الكارثة الأعظم ليست في السلطة، بل في الشعب.
في ذاكرته القصيرة، في خضوعه المتكرّر، في ميله إلى التصفيق للمألوف ولو كان ظالماً.
فيا للأسى نحن لسنا من الشعوب التي تتعلم من الوجع، ولسنا من الأمم التي تحفظ دروس التاريخ.
كم مرة هُزم الحلم وكم هُدم من أمل أمام أعيننا، وكم سُرقت ثورات، وأُجهضت صحوات، ثم عدنا نصطف من جديد تحت ذات الشعار، وذات الصولجان، وذات السياف وخلف الجلاد ذاته وإن تغير اسمه.
كم مرة تكرّرت المسرحية، بنفس السيناريو، والموسيقى التصويرية ذاتها، مع تغيير طفيف في الممثلين، ودون أن يتغيّر الجمهور؟
شعبنا، للأسف، بلا ذاكرة.
ينسى من خذله بالأمس .. ينسى من خان، ويغفر لمن نهب، ويُصفّق لمن هدم، ثم يبكي حين يُسحق من جديد.
ولأن السلطة تعرف هذا، فهي لا تبذل جهدًا لتتغيّر، بل تراهن على النسيان، وتُعيد عرض نفس المسرحية على خشبة قديمة ووجوه ذاهلة.
وما لم نستعد ذاكرتنا، فلن نستعيد وطنًا،
وسنبقى نبني للهدم، ونفرح بالخراب، وننتظر التغيير من يدٍ هي أصل البلاء
وسيبقى الركام سيد الحكاية، والعَدم هو المآل
لكن التاريخ – مرة أخرى – يُعلّمنا أن الدول التي تبني على الهدم، لا تدوم، وأن الأنظمة التي تُلهى شعوبها بالتفرقة وبالخوف من المجهول، ستصحو يومًا على صلصلة صوت الحقيقة المجلجل، حين يفوت الأوان.